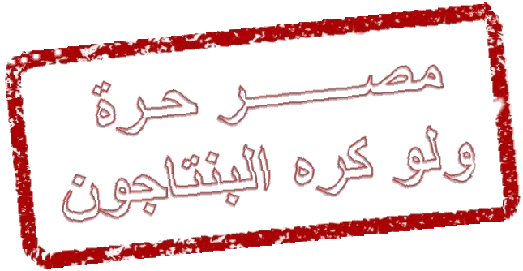---------------------------------------------
لثقتي بأني سأفشل في الوصف الدقيق، لم أسع أثناء الكتابة، إلى تفصيل بعض الأحداث الهامة خلال علاقتي بالشارع الثوري الذي كان مدخله محاولة زيادة "التفاعل الإنساني" لدي.
مررت بعدة مواقف "إنسانية" منها الصادم ومنه الرائع، قضيت أيامًا غريبة حيث الضحك والبكاء متتابعين، والإحباط والأمل بينهما ما بين الدقيقة والتي تليها. أقف عند البكاء، وهو كان أحد الشواهد على مشكلتي في التفاعل إنسانيًا، فأنا لدي إلى الآن مشكلة مع البكاء، أنا لا أبكي، إلا كل بضعة أعوام مرة، ولا أفهم لغة البكاء، ولكن 2011 الجوادة أمطرتني بكاءًا أكثر من مرة في عام واحد، وليس في جميع الأوقات حين ينبغي ذلك، ففي قليل من الأحيان كان الصداع النصفي المعتاد الذي يطل من وقت لآخر مع الأحداث الصعبة، وفي أحيان أخرى حين يتعسر البكاء مع وجوبه، كانت بعض الشعيرات الدموية تتقطع أسفل جلدي غاضبة مستعيضة عن البكاء، ذلك حدث مثًلا أثناء مذبحتي ماسبيرو ومحمد محمود.
حقًا إن الإحساس نعمة بكل وسائله، ولا يعد أساسًا أن نمتلك جميعًا ذات الأدوات في الكم والكيف، فإن الأساس يكمن في الصدق والتخلص من الزيف، وعدم إلقاء بيوت الآخرين بالحجارة في حين أننا بنينا بيوتنا زجاجًا هشًا.
ولقد تكشف جانبًا من الزيف بداخلي وهشاشة زجاجي، في أيام اعتصام 8 يوليو، حين كنت أجلس مع صديقة أمام إحدى الخيمات وزارنا طفل صغير لا يتعدى عمره ست سنوات فصيحًا جلس يتحدث معنا، من أول نظرة "تصنيفية"، صنفته من أطفال الشوارع. هذه كانت أول مرة يجلس طفل شارع ويتحدث معي، صمت قليلًا بعد فترة من الحديث، حاولت أن أبحث عن أي حلوى معي لم أجد شيئًا، كان معي زجاجات مياه كثيرة، سألته هل تشعر بالعطش ومددت إليه واحدة، رفض وهذه أول مرة أجد طفل شارع متمنعًا عما أقدم، سألته عن السبب، فأجاب بأنه لن يأخذها لنفسه بل سيعطيها لأمه. ذهبت إلى أن أربط قدرته على الابتسام بأنه طفل شارع يعيش مع أمه وتلك حالة نادرة الحدوث، على الأقل بحسب ما شاهدت من قبل. وقلت له أن لا بأس بأن يعطيها لأمه ويشربوها سويًا، ثم أخرجت القليل من المال وأعطيته له حتى يشتري حلوى، فأخذها متبرقةً أسارير وجهه، ثم انقلب بظهره إلى الخلف ومد يده نحوي، لم أفهم ماذا يقصد في البداية، فكررها ففهمت أنه يلهو، ويجب علي أن آخد بيده وأن أسحبه قبل أن ينقلب، فترددت لم أكن واثقة أني أستطيع الإمساك بيده، ففهمت صديقتي، ومسكت يده على الفور وسحبته ففرح، وأخرجت هي الأخرى بعض المال وأعطته له، ثم قال لي "أريد أن أرى هذه القبعة"، كنت أربطها بحقيبة الظهر، فابتسمت، لم ينتظر رأيي وشدها ووضعها فوق رأسه، وسألني "ما رأيك؟". حاولت صديقتي منعه عن القيام بذلك، لأنه من العيب أن يأخذ شيئًا ليس ملكه، ولم تُعجب بالطريقة التي وصلت بها القبعة على رأسه. لكني لم أحسن التصرف للمرة الثانية وقلت له "أراها تناسبك وتبدو بها رائعًا، إنها لك"، ذلك لأني لم أكن واثقة أني سأستطيع ارتداؤها مرة أخرى.
وبعد ذلك الكشف السريع، أدركت أن تصرفي هو القذر وليس يد الطفل أو ملابسه، ما كان ليحدث شيئًا لو كنت مسكت يده وسحبته كما كان يريد. لم أكن قد تحدثت إلى أي طفل شارع أو جلست معه، كنت، للأسف كل ما أقوم به عند مقابلة أحدهم، هو إخراج شيئًا من حقيبتي، وإعطاؤه إياه بسرعة، حرصًا على ألا ألمس يده.
كان ذلك اختبارًا قاسية، لم أنجح به، وإن كنت بعد ما رأيت صديقتي سليمة معافاة، أقصد سليمة النفس قبل الصحة، وبعد أن أدركت أن عقلي ملوث انشغل بالظاهر والسطحي عن الأساس الداخلي، قد حاولت أن أنتهز فرصة مقابلة أي طفل شارع آخر ومصافحته أو التربيت على الكتف أو أي شيء أظهر به أمام نفسي أني قد تخلصت من ذلك الزيف، وإن كنت لا أظن إلى الآن أني سأشعر أني قد تخلصت منه ذلك الزيف تمامًا إلا بعد مقابلة الطفل نفسه مرة أخرى، وأحاول أن أصحح موقفي، لأني أظنه قد فهم، وأنا الغبية.
وأود أن أربط ما سبق بأن أخص بالذكر أسوأ اللحظات التي مررت بها خلال تلك الرحلة الكاشفة، حين كان يتحدث الآخرون عن زيف الآخر وصدمتهم، وهم الذين كانوا صدمتي الأمس، فهم من يصدر عنهم زيف مصحوبًا بإلقاء الآخرين بالطوب، ينقدون ما يجترحونه، في الآخرين لا في أنفسهم. الصادمون مصدومون؟! إني إذًا مثلهم، فكما هم يصدمون الآخرين بأفعالهم وتصدمهم أفعال الآخرين، قد أكون مثلهم أصدم كما أُصدم، لا أجد مبررًا لاستثناء نفسي، فقد أضل الطريق وأظن أني أحسن صنعًا.
لا خبر عندي بموعد الاختبار القادم، وأتحسب قدومه "ربنا يستر" لا أعلم ما سيتكشف من زيف آخر بداخلي، وما إذا كنت سأستطيع التعامل معه، والتخلص منه تخلصًا آمنًا أم أنه سيرافقني طويلًا.
لم تنته الرحلة ولا أريد لها أن تنتهي حتى ينتهي التكشُف الذي أظنه بعمر العمر. صحيح أن الإنسان ضعيف بترقيق الضاد إلى الدال ومد الياء كما شئت، لكن أحدٌ لن يكون إلا بالتكوين، أي أن يكون جزءًا من هذا التكوين فيتكون هو الآخر، تجنبًا للتكرار، هذه التدوينة تخبرنا عن المقصد بسلاسة.
صامدون:
عمدت استخدام ألفاظ مثل "قلة" أو "كثرة" أو "بعض" أو "معظم" أو "غالبًا" بُغضًا في التعميم الذي لا محل له هنا وغير هنا. وأتذكر أني إخترت أن أستخدم تعبير "في الغالب" حين وصفت امتلاء البالونة بالهواء، لأني لا زلت أجد قدرًا من الأصالة من حولي، قدرًا أستطيع أن أتلحف به، وأن أعتصم به فيعصمني. فما يزال هناك من يخفت بريق اللآلئ وكريم الأحجار في حضرتهم وعند ذكرهم. هم الذين لم يُستهلكوا بعد وينأون قدر المستطاع بأنفسهم عن ميكنة الاستنزاف المستشرية. أظن أن الغالبية قد بدأت مثلهم ثم نكبوا عن الصراط عند لحظة ما. ولكني أجد هؤلاء صامدون إلى الآن خلال رحلة التكشف الخاصة بكل منهم، يكسرون حواجز الخوف ويعبرون أسوار الاستمالة، ويتقدمون تاركين الإحباط خلف ظهورهم والإيمان ظهيرهم، ويتوقون إلى الشهادة أكثر من أي شيء على الأرض، لا رغبة مستترة في التخلص من الحياة، بل لأنهم قلبوا الدنيا أولها لآخرها فزهدوا عنها، وطالما بقوا فيها، فهم ماضون لتحقيق الحكمة من وجودهم معتبرين في ذلك الحياة أداة لا غاية. أظن أنهم من صنوف تلك الأرواح التي إلتقيت بها، في أوائل شهر يوليو الماضي، حين كنت أستقل حافلة إلى مطار القاهرة، وشعرت فجأة بقشعريرة تجتاح صدري، ونظرت إلى خارج النافذة فوجدتنا على مستوى الأدوار العلوية للبنايات، سألت "أين نحن الآن؟"، فأجاب أكثر من واحد مزهوًا "أنت الآن فوق كوبري قصر النيل". لا بد وأن المكان تفيض على أصالته الجنة بريحها في كل يوم منذ ذلك اليوم، يوم زحف الأبطال، فقرأت الفاتحة داعيةً لهم ولنا بالرحمة.
أتوقف هنا عن مطالعة قصاصات وصور الرحلة، حتى أتقاسم ما شرد إليه ذهني، فيما يخص أن الرحلة لا تنتهي عند هذا الحد ولا يجب لها أن تنتهي. فقد يوحي السابق من الطرح أن بآخر الطريق سدًا. غير أني لا أرى ذلك، إلا في حال إصرارنا على الاستمرار على سابق عهدنا وتجاربنا بانتظار نتائج مختلفة، في حين أن في الآفاق وفي أنفسنا سبل لا تفنى.
وبالرجوع إلى فكرة التكوين خلال هذه المرحلة التي تفشى العبث فيها أكثر من أي شيء، أؤمن أنه بالإمكان تقليص تجربة اعتقادنا بأهمية الانتماءات والاعتقاد بقوة خارقة لفريق كونه وحده هو القادر على العبور إلى البر.
أظن بوجوب التفكيك وإعادة التشكل لا وفقًا لانتماءات فكرية تنتهي باستنزاف مجهودها في التشاحن والتصارع مع الآخر ويسهل على الجهات القمعية الداخلية أو الخارجية السيطرة عليها وتدجينها وإيهامها بأنها تقوم بعملٍ ذي قيمة.
ماذا لو تلاشت التصنيفات وفقًا للانتماءات الفكرية وأفسحنا المجال للانتماءات المكانية؟ ماذا لو عمل كل فرد مع أهله وناسه، هل سيخرج الإعلام علينا معاديًا أهل منطقة كذا دون كذا؟ كي نكسر المركزية سواء المتمثلة في التركيز على مكان واحد كأنه محور الحياة أو على بعض المجموعات ورموز أفرادها، وكأن المشاركة يجب أن تظل قاصرة على فئات محددة، وباقي الجمهور ينجر وراء هذه أو تلك إلى هنا أو هناك بحسب "المصلحة".
روى لنا الماضى القريب والبعيد كيف يتم اختزال الجماهير في فئات وكيف يتم اختزال الفئات إلى أفراد يسهُل استهدافهم إما بالاستمالة أو التخلص النهائي ممن تسول له نفسه الامتناع عن التعاون، ذلك دون التخلص مما كان يمثله هذا المخلِص، ودون ترك مقعده خاليًا، بل يضعون آخرين من قِبلهم يأتمرون بأمرهم.
في حين أن جميع الناس أتوا إلى هذه الحياة للحكمة ذاتها، إلا أنه بعد عصور مزمنة من انتهاك الفطرة، بات يُطلق على تحرك الجمع "ثورة" وما هي بثورة، إنما هي فطرة الله التي فطر عليها عباده، ما يحدث من تحرك للجموع إنما هو عودة للفطرة.
بشيء من حسن التخطيط، يمكن الاستفادة جيدًا بالكثرة العددية والموارد البشرية للاستعاضة عن ضعف الموارد المالية. ويجب التدقيق فيما يُعرض من مساعدات من خارج مجموعات العمل، إن كانت من جهة ممولة داخليًا من تبرعات شركة تعمد إلى تخفيض ضرائبها فقط أم أنها أيضًا مدخل للتدخل الأمني، أم أنها مدخل للتدخل الخارجي الذي يعمد إلى نخر المجتمع من أساسه.
أظن وقد يتكشف لي لاحقًا أني لم أحسن التفكير، فالله أعلم، أن التوجه للعمل بهذا المنطق، لن يسمح بسهولة لأي جهة ركوب الأفراد وجعلهم مطية لأهوائهم أو الحد من تطلعهم إلى القيم التي يعملون من أجل تحقيقها، تطلعهم هذا الذي يبدأ بالجزم والآراء القاطعة الباترة ثم عدم التيقن ثم الحلول الوسط ثم العدمية.
أفصل خطاب التدوينة بالتذكير مرة أخرى من غرض كتابتها: أنه بغض النظر عن المعتقدات والانتماءات إن كنا نسلك ذات طريق الآخر فقط بشكل مختلف نظن من خلاله أننا سنقلب الطاولة على العدو ونحن الغالبون في حين أننا من هذا المنطق لا نختلف عن آخرين فلا داعي للتقاذف بالطوب وإيهام الغير بأننا مختلفون مميزون رائعون أنقياء. والحكم القديمة تخبرنا بأن الحداية لا تهدي فراخًا وأن المُغطى بالقوى التي يحاربها عاري وأن من بيته من الزجاج لا يقذف غيره بالحجارة.
إن كنا وجدنا بداخلنا هذا الصنف من الازدواجية قد نود مراجعة أنفسنا قبل المتابعة، وإن لم نكن كذلك فلا نتوقف عن متابعة الطريق في رحلة التكشف. ولا نترك الميادين، فإن فيها خلاصنا، ولنرابط على الايمان والأمل، لأن الأمل صلاة والصلاة صلة عند الذي لا ينقطع عنده الرجاء.
لا خبر عندي بموعد الاختبار القادم، وأتحسب قدومه "ربنا يستر" لا أعلم ما سيتكشف من زيف آخر بداخلي، وما إذا كنت سأستطيع التعامل معه، والتخلص منه تخلصًا آمنًا أم أنه سيرافقني طويلًا.
لم تنته الرحلة ولا أريد لها أن تنتهي حتى ينتهي التكشُف الذي أظنه بعمر العمر. صحيح أن الإنسان ضعيف بترقيق الضاد إلى الدال ومد الياء كما شئت، لكن أحدٌ لن يكون إلا بالتكوين، أي أن يكون جزءًا من هذا التكوين فيتكون هو الآخر، تجنبًا للتكرار، هذه التدوينة تخبرنا عن المقصد بسلاسة.
صامدون:
عمدت استخدام ألفاظ مثل "قلة" أو "كثرة" أو "بعض" أو "معظم" أو "غالبًا" بُغضًا في التعميم الذي لا محل له هنا وغير هنا. وأتذكر أني إخترت أن أستخدم تعبير "في الغالب" حين وصفت امتلاء البالونة بالهواء، لأني لا زلت أجد قدرًا من الأصالة من حولي، قدرًا أستطيع أن أتلحف به، وأن أعتصم به فيعصمني. فما يزال هناك من يخفت بريق اللآلئ وكريم الأحجار في حضرتهم وعند ذكرهم. هم الذين لم يُستهلكوا بعد وينأون قدر المستطاع بأنفسهم عن ميكنة الاستنزاف المستشرية. أظن أن الغالبية قد بدأت مثلهم ثم نكبوا عن الصراط عند لحظة ما. ولكني أجد هؤلاء صامدون إلى الآن خلال رحلة التكشف الخاصة بكل منهم، يكسرون حواجز الخوف ويعبرون أسوار الاستمالة، ويتقدمون تاركين الإحباط خلف ظهورهم والإيمان ظهيرهم، ويتوقون إلى الشهادة أكثر من أي شيء على الأرض، لا رغبة مستترة في التخلص من الحياة، بل لأنهم قلبوا الدنيا أولها لآخرها فزهدوا عنها، وطالما بقوا فيها، فهم ماضون لتحقيق الحكمة من وجودهم معتبرين في ذلك الحياة أداة لا غاية. أظن أنهم من صنوف تلك الأرواح التي إلتقيت بها، في أوائل شهر يوليو الماضي، حين كنت أستقل حافلة إلى مطار القاهرة، وشعرت فجأة بقشعريرة تجتاح صدري، ونظرت إلى خارج النافذة فوجدتنا على مستوى الأدوار العلوية للبنايات، سألت "أين نحن الآن؟"، فأجاب أكثر من واحد مزهوًا "أنت الآن فوق كوبري قصر النيل". لا بد وأن المكان تفيض على أصالته الجنة بريحها في كل يوم منذ ذلك اليوم، يوم زحف الأبطال، فقرأت الفاتحة داعيةً لهم ولنا بالرحمة.
أتوقف هنا عن مطالعة قصاصات وصور الرحلة، حتى أتقاسم ما شرد إليه ذهني، فيما يخص أن الرحلة لا تنتهي عند هذا الحد ولا يجب لها أن تنتهي. فقد يوحي السابق من الطرح أن بآخر الطريق سدًا. غير أني لا أرى ذلك، إلا في حال إصرارنا على الاستمرار على سابق عهدنا وتجاربنا بانتظار نتائج مختلفة، في حين أن في الآفاق وفي أنفسنا سبل لا تفنى.
وبالرجوع إلى فكرة التكوين خلال هذه المرحلة التي تفشى العبث فيها أكثر من أي شيء، أؤمن أنه بالإمكان تقليص تجربة اعتقادنا بأهمية الانتماءات والاعتقاد بقوة خارقة لفريق كونه وحده هو القادر على العبور إلى البر.
أظن بوجوب التفكيك وإعادة التشكل لا وفقًا لانتماءات فكرية تنتهي باستنزاف مجهودها في التشاحن والتصارع مع الآخر ويسهل على الجهات القمعية الداخلية أو الخارجية السيطرة عليها وتدجينها وإيهامها بأنها تقوم بعملٍ ذي قيمة.
ماذا لو تلاشت التصنيفات وفقًا للانتماءات الفكرية وأفسحنا المجال للانتماءات المكانية؟ ماذا لو عمل كل فرد مع أهله وناسه، هل سيخرج الإعلام علينا معاديًا أهل منطقة كذا دون كذا؟ كي نكسر المركزية سواء المتمثلة في التركيز على مكان واحد كأنه محور الحياة أو على بعض المجموعات ورموز أفرادها، وكأن المشاركة يجب أن تظل قاصرة على فئات محددة، وباقي الجمهور ينجر وراء هذه أو تلك إلى هنا أو هناك بحسب "المصلحة".
روى لنا الماضى القريب والبعيد كيف يتم اختزال الجماهير في فئات وكيف يتم اختزال الفئات إلى أفراد يسهُل استهدافهم إما بالاستمالة أو التخلص النهائي ممن تسول له نفسه الامتناع عن التعاون، ذلك دون التخلص مما كان يمثله هذا المخلِص، ودون ترك مقعده خاليًا، بل يضعون آخرين من قِبلهم يأتمرون بأمرهم.
في حين أن جميع الناس أتوا إلى هذه الحياة للحكمة ذاتها، إلا أنه بعد عصور مزمنة من انتهاك الفطرة، بات يُطلق على تحرك الجمع "ثورة" وما هي بثورة، إنما هي فطرة الله التي فطر عليها عباده، ما يحدث من تحرك للجموع إنما هو عودة للفطرة.
بشيء من حسن التخطيط، يمكن الاستفادة جيدًا بالكثرة العددية والموارد البشرية للاستعاضة عن ضعف الموارد المالية. ويجب التدقيق فيما يُعرض من مساعدات من خارج مجموعات العمل، إن كانت من جهة ممولة داخليًا من تبرعات شركة تعمد إلى تخفيض ضرائبها فقط أم أنها أيضًا مدخل للتدخل الأمني، أم أنها مدخل للتدخل الخارجي الذي يعمد إلى نخر المجتمع من أساسه.
أظن وقد يتكشف لي لاحقًا أني لم أحسن التفكير، فالله أعلم، أن التوجه للعمل بهذا المنطق، لن يسمح بسهولة لأي جهة ركوب الأفراد وجعلهم مطية لأهوائهم أو الحد من تطلعهم إلى القيم التي يعملون من أجل تحقيقها، تطلعهم هذا الذي يبدأ بالجزم والآراء القاطعة الباترة ثم عدم التيقن ثم الحلول الوسط ثم العدمية.
أفصل خطاب التدوينة بالتذكير مرة أخرى من غرض كتابتها: أنه بغض النظر عن المعتقدات والانتماءات إن كنا نسلك ذات طريق الآخر فقط بشكل مختلف نظن من خلاله أننا سنقلب الطاولة على العدو ونحن الغالبون في حين أننا من هذا المنطق لا نختلف عن آخرين فلا داعي للتقاذف بالطوب وإيهام الغير بأننا مختلفون مميزون رائعون أنقياء. والحكم القديمة تخبرنا بأن الحداية لا تهدي فراخًا وأن المُغطى بالقوى التي يحاربها عاري وأن من بيته من الزجاج لا يقذف غيره بالحجارة.
إن كنا وجدنا بداخلنا هذا الصنف من الازدواجية قد نود مراجعة أنفسنا قبل المتابعة، وإن لم نكن كذلك فلا نتوقف عن متابعة الطريق في رحلة التكشف. ولا نترك الميادين، فإن فيها خلاصنا، ولنرابط على الايمان والأمل، لأن الأمل صلاة والصلاة صلة عند الذي لا ينقطع عنده الرجاء.